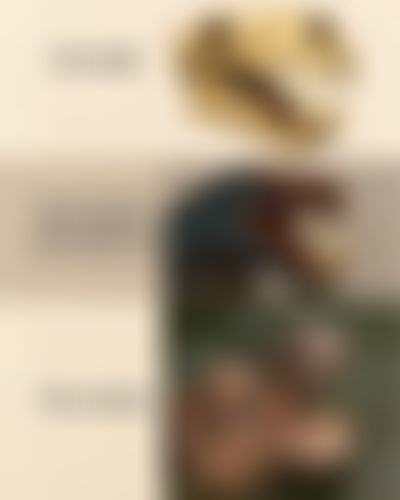قناة | الغيث الشامي (أبحاث)
مستودع أبحاث (في المعرفة والعلم والأخلاق والسياسة).
القناة الرئيبسية: https://t.me/AboObadaShami
القناة الرئيبسية: https://t.me/AboObadaShami
"قناة | الغيث الشامي (أبحاث)" 群组最新帖子
20.05.202507:42
تصور أن رجلا قال لمحاوره: "زيد كريم/ الله موجود" أو غير ذلك من الأمثلة، فسأله محاوره: ما إعراب "الله / زيد" في كلامك؟
فلم يعرف الرجل إعرابه، هل يضره في تقرير دعواه ويتوقف البحث على ذلك؟ الجواب: لا.
إذا لم يعرف هل هو موضوع أم محمول وهل كلامه قضية حملية أم شرطية -بهذا الاصطلاح- هل يضره ويتوقف دعواه على ذلك؟ لا.
في أكثر ما سمعت من كلام حتى المشتغلين بصناعة البرهان المتشبثين بأذيالها تجدهم حال ردهم على مخالفهم يقولون ما صورته: الخصم لم يعرف كذا وكذا من التوصيف المنطقي لحجته أو لقضيته ويشنعون عليه وأنه جاهل، مع كونه عرف أو لم يعرف لا يضره في كون حجته صحيحة أم لا، فلم يفعل ذلك كثير من الناس؟
الحقيقة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بالمنطق أن الناس بما فيهم المتشبث بأذيال المنطق والبرهان يستبطنون أصلا وهو: أن الحجة ملتئمة من الدليل المذكور والمتكلم بالدليل! فمن مقومات الحجة المتكلم بها، وإسقاطه مؤثر في نفوس كثير من الناس في الحجة أدركوا أو لم يدركوا، وهذا إذا تأملته وجدت أكثر الناس ينكرونه باللسان ويستبطنونه في موارد كثيرة! لا أقول في كل الموارد لكنه في موارد كثيرة، ولذا جعل بعض المحدثين المعاصرين من أركان الدليل المتكلم به وعقد بحثا لذلك!* وهذا لو رأيتُه قديما لضحكت وسخرت منه، لكن من تأمل ودقق في أحوال الناس حتى الخواص وجد هذا الإضمار حاصلا في نفوسهم.
هل حصوله في نفوسهم يجعله صوابا؟
الجواب: فليكن ليس صوابا، لكن إغفاله ليس صوابا أيضا، فإنه ليس في قوتك تبديل نفوس الخلق.
* أما المناطقة الأقدمون فبحثوا ذلك في موضعين فيما أذكر: في المغالطة الخارجية والخطابة وغيرهما لكن بحثهم إجمالي جدا.
@ https://t.me/IFALajmi/3506
فلم يعرف الرجل إعرابه، هل يضره في تقرير دعواه ويتوقف البحث على ذلك؟ الجواب: لا.
إذا لم يعرف هل هو موضوع أم محمول وهل كلامه قضية حملية أم شرطية -بهذا الاصطلاح- هل يضره ويتوقف دعواه على ذلك؟ لا.
في أكثر ما سمعت من كلام حتى المشتغلين بصناعة البرهان المتشبثين بأذيالها تجدهم حال ردهم على مخالفهم يقولون ما صورته: الخصم لم يعرف كذا وكذا من التوصيف المنطقي لحجته أو لقضيته ويشنعون عليه وأنه جاهل، مع كونه عرف أو لم يعرف لا يضره في كون حجته صحيحة أم لا، فلم يفعل ذلك كثير من الناس؟
الحقيقة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بالمنطق أن الناس بما فيهم المتشبث بأذيال المنطق والبرهان يستبطنون أصلا وهو: أن الحجة ملتئمة من الدليل المذكور والمتكلم بالدليل! فمن مقومات الحجة المتكلم بها، وإسقاطه مؤثر في نفوس كثير من الناس في الحجة أدركوا أو لم يدركوا، وهذا إذا تأملته وجدت أكثر الناس ينكرونه باللسان ويستبطنونه في موارد كثيرة! لا أقول في كل الموارد لكنه في موارد كثيرة، ولذا جعل بعض المحدثين المعاصرين من أركان الدليل المتكلم به وعقد بحثا لذلك!* وهذا لو رأيتُه قديما لضحكت وسخرت منه، لكن من تأمل ودقق في أحوال الناس حتى الخواص وجد هذا الإضمار حاصلا في نفوسهم.
هل حصوله في نفوسهم يجعله صوابا؟
الجواب: فليكن ليس صوابا، لكن إغفاله ليس صوابا أيضا، فإنه ليس في قوتك تبديل نفوس الخلق.
* أما المناطقة الأقدمون فبحثوا ذلك في موضعين فيما أذكر: في المغالطة الخارجية والخطابة وغيرهما لكن بحثهم إجمالي جدا.
@ https://t.me/IFALajmi/3506
20.05.202507:42
19.05.202510:42
هذا يذكرني بمناقشة للرازي نقلها ابن القيم في الصواعق المرسلة:
حيث يقول الرازي:
قلت:
العجيب أن الرازي أصلًا يناقش الخصم على التسليم وإلا فإنه نبه أولًا أن الإلزام كله غير لازم فهب أن الله لبس على الخلق فما المانع من ذلك؟ يقول لهم هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وأن العقل يعلم أن الله يتنزه عن القبائح كالتلبيس والكذب وهذا لا يسلمه الرازي وأمثاله!!
فكيف فرقوا بين ما خلقه الله من "ألفاظ بين دفتي المصحف" وبين ما خلقه من ضروريات في نفوسهم؟! إذ الاثنين يمكن التلبيس فيهم والكذب من إله لا يتنزه عن القبائح
لذلك مازلت أقول إن من أقبح أقوال الأشاعرة نفيهم للتحسين والتقبيح وأنه بوابة عظيمة للسفسطة حتى ألزمهم خصومهم بجواز تأييد الله سبحانه "تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا لمدعي النبوة الكذاب بالمعجزات!
وكذلك بعض القائلين بالإعجاز العلمي يلزمهم شيء مما ذكره الرازي من وجه آخر وهو امتناع أن تأخذ كلام الله سبحانه في الطبيعيات الغيبية المغيبة تغيبًا مطلقًا والتي أصلًا يكون تنظير الطبيعيين فيها سفاهة وقلة أدب على محمل الجدية لاحتمال أن يكتشفوا خلاف ما تدل عليه ظاهر الآية لغويّا، بل واحتمال أن يكتشفوا ما به يثبت غلط ما فسرت أنت به الآية سابقًا من نظريات طبيعية في الباب!
فالقران مفتوح للعب على أوسع نطاق لكل من شاء أن يحمل أي آية على أي نظرية وكأنه ليس كلام الله المبين العظيم، فسبحان الله، ماذا جنيتم على الدين يا هؤلاء.
#الغيث_الشامي
حيث يقول الرازي:
"فإن قيل: إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل وإلا كان ذلك تلبيسا من الله تعالى وإنه غير جائزيقول ابن القيم معلقًا على هذا الكلام:
قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح وأنه يجب على الله سبحانه شيء ونحن لا نقول بذلك ثم إن سلمنا ذلك فلم قلتم إنه يجب على الله أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل العقلي وبيانه أن الله تعالى إنما يكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره وليس الأمر كذلك لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهر فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام فلو قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا كان ذلك التقدير تقصيرا واقعا من المكلف لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع.
فليتدبر المؤمن هذا الكلام وليرد أوله على آخره وآخره على أوله ليتبين له ما ذكرنا عنهم من العزل التام للقرآن والسنة عن أن يستفاد منهما علم أو يقين في باب معرفة الله وما يجب له وما يمتنع عليه وأنه لا يجوز أن يحتج بكلام الله ورسوله في شيء من هذه المسائل وأن الله تعالى يجوز عليه التلبيس والتدليس على الخلق وتوريطهم في طرق الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال وأن العباد مقصرون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله على حقيقته وقطعوا بمضمون ما أخبر به حيث لم يشكوا في ذلك إذ قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه.انتهى كلامه
قلت:
العجيب أن الرازي أصلًا يناقش الخصم على التسليم وإلا فإنه نبه أولًا أن الإلزام كله غير لازم فهب أن الله لبس على الخلق فما المانع من ذلك؟ يقول لهم هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وأن العقل يعلم أن الله يتنزه عن القبائح كالتلبيس والكذب وهذا لا يسلمه الرازي وأمثاله!!
فكيف فرقوا بين ما خلقه الله من "ألفاظ بين دفتي المصحف" وبين ما خلقه من ضروريات في نفوسهم؟! إذ الاثنين يمكن التلبيس فيهم والكذب من إله لا يتنزه عن القبائح
لذلك مازلت أقول إن من أقبح أقوال الأشاعرة نفيهم للتحسين والتقبيح وأنه بوابة عظيمة للسفسطة حتى ألزمهم خصومهم بجواز تأييد الله سبحانه "تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا لمدعي النبوة الكذاب بالمعجزات!
وكذلك بعض القائلين بالإعجاز العلمي يلزمهم شيء مما ذكره الرازي من وجه آخر وهو امتناع أن تأخذ كلام الله سبحانه في الطبيعيات الغيبية المغيبة تغيبًا مطلقًا والتي أصلًا يكون تنظير الطبيعيين فيها سفاهة وقلة أدب على محمل الجدية لاحتمال أن يكتشفوا خلاف ما تدل عليه ظاهر الآية لغويّا، بل واحتمال أن يكتشفوا ما به يثبت غلط ما فسرت أنت به الآية سابقًا من نظريات طبيعية في الباب!
فالقران مفتوح للعب على أوسع نطاق لكل من شاء أن يحمل أي آية على أي نظرية وكأنه ليس كلام الله المبين العظيم، فسبحان الله، ماذا جنيتم على الدين يا هؤلاء.
#الغيث_الشامي
19.05.202509:41
هل لنا أن نعرف أن ما يسمى الكتاب المقدس أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أم لا؟
من أشهر المسالك في ذلك مسلك التناقضات في الكتاب المقدس، وهذا المسلك لا يستمر الاحتجاج بكثير من صوره على الطريقة الدائرة في كتب المتكلمين، فإنه للنصراني أن يقول: كل ما في الكتاب من تناقضات ونحوها محمولة على محامل صحيحة دفعًا للتعارض وعملا بالقواطع العقلية الدالة على كون كلام الإله معصوما من الخطأ.
وكذلك غير التناقضات من الأمور الباطلة، فلو قدر أن القواطع العقلية تدل على أن الولادة على الإله* مستحيلة فلا يدل ذلك على بطلان ديننا بل غاية ما في المقام أن الكلمات الإلهية ليست على ما فهمنا ويجب تأويلها وصرفها لمحامل صحيحة يجب الأخذ بها.
فلا يستطيع السائر على الطريقة الكلامية في كثير من الموارد إبطال نسبة كلام ما إلى الإله بالنظر لنفس الكلام.
* هذا على القول بثبوت ذلك في كتابهم.
@ https://t.me/IFALajmi/3520
من أشهر المسالك في ذلك مسلك التناقضات في الكتاب المقدس، وهذا المسلك لا يستمر الاحتجاج بكثير من صوره على الطريقة الدائرة في كتب المتكلمين، فإنه للنصراني أن يقول: كل ما في الكتاب من تناقضات ونحوها محمولة على محامل صحيحة دفعًا للتعارض وعملا بالقواطع العقلية الدالة على كون كلام الإله معصوما من الخطأ.
وكذلك غير التناقضات من الأمور الباطلة، فلو قدر أن القواطع العقلية تدل على أن الولادة على الإله* مستحيلة فلا يدل ذلك على بطلان ديننا بل غاية ما في المقام أن الكلمات الإلهية ليست على ما فهمنا ويجب تأويلها وصرفها لمحامل صحيحة يجب الأخذ بها.
فلا يستطيع السائر على الطريقة الكلامية في كثير من الموارد إبطال نسبة كلام ما إلى الإله بالنظر لنفس الكلام.
* هذا على القول بثبوت ذلك في كتابهم.
@ https://t.me/IFALajmi/3520
18.05.202523:44
18.05.202523:36
18.05.202523:30
فصلٌ: هل اتفاق البشر كاشف على البداهة، وخلافهم رافع لها؟
الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبِه ومن اهتدى بهديه، أما بعد: اعلم أن هذا الموضع قد كثر فيه اضطراب النظار، ونحن نذكر تحقيقه ببعض ما جادت به القريحة فنقول:
اعلم أن وفاق بني آدم على حكمٍ من الأحكام، إن وقع في موضعٍ لا يُتصور فيه التواطؤ، ولا اشتركوا فيه بتلقينٍ سابق، أو عادةٍ موروثة، أو المشاركة في سببٍ خارجٍ عن محض العقل والفطرة، فمثل هذا الاتفاق -وإن كان أغلبيا- كاشف على البداهة؛ وحجة على المخالف (إن كان يسلم أن هناك حالة هي حكم الأصل في البشر، يعمل فيها العقل على النحو السليم، وهذا متوقف على ثبوت الباري تحقيقا).
أما إن وقع الوفاق في موضعٍ يُعلم فيه الاشتراك في المذهب أو التلقين أو العادة، كما اتفقت الأمم المشركة على عبادة الأوثان، أو القول بالثالوث، ونحو ذلك مما هو مخالف لصريح العقل، فهو من جنس ما يُعلم أنه من أثر التقليد والغلبة، فلا يكون دالًا على بداهة، ولا حجة على المخالف.
وأما القول في الخلاف أهو رافع للبداهة أم لا؟ فإن ذلك إنما يصح لو كانت أسباب الخلاف محصورة في عمل العقل السليم، وهو باطل؛ فإننا نعلم بالضرورة أن من الخلق من يختارون أعظم الأقوال سفسطة وظهورا في البطلان لأسباب لا يحصيها إلا الله، مرجعها إجمالا إلى النفس وهواها، كحب التميز والرياسة أو اتباع ما ألفوه من آبائهم ونحوه.
وقد يكون أصل الفساد من جهة النظر الكلي، ثم يُبنى عليه ما بعده، فيضل في الجزئيات تبعًا لذلك، وإن لم يكن له فيها هوى مخصوص، كما ترى من يسفسط في الأمور الظاهرة لكونه ألِف ضربًا من الجدل والمراء، ثم يطرد ذلك في مسائل لا موجب فيه لذلك لولا ما تقدمه؛ وهذا شأن عامة الفلاسفة.
ولهذا فحصول الخلاف في عصرنا حول قبح الشذوذ الجنسي -مثلا- لا يرفع حكم الفطرة بقبحه، لعلمنا بمداخل الهوى في قول المخالفين، وكون الحكم الأغلبي الذي يمتنع فيه التواطئ على خلافهم.
فإن أمكن – وهو عسير – أن تُعزل المؤثرات الخارجية، ويُتحقق تجرد العقل، وسلامة القصد، واستواء النظر بين المختلفين، ثم وُجد الخلاف في الحكم، دلّ ذلك على خفاء محل النزاع، وأنه ليس من الواضحات البدهيات.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبِه ومن اهتدى بهديه، أما بعد: اعلم أن هذا الموضع قد كثر فيه اضطراب النظار، ونحن نذكر تحقيقه ببعض ما جادت به القريحة فنقول:
اعلم أن وفاق بني آدم على حكمٍ من الأحكام، إن وقع في موضعٍ لا يُتصور فيه التواطؤ، ولا اشتركوا فيه بتلقينٍ سابق، أو عادةٍ موروثة، أو المشاركة في سببٍ خارجٍ عن محض العقل والفطرة، فمثل هذا الاتفاق -وإن كان أغلبيا- كاشف على البداهة؛ وحجة على المخالف (إن كان يسلم أن هناك حالة هي حكم الأصل في البشر، يعمل فيها العقل على النحو السليم، وهذا متوقف على ثبوت الباري تحقيقا).
أما إن وقع الوفاق في موضعٍ يُعلم فيه الاشتراك في المذهب أو التلقين أو العادة، كما اتفقت الأمم المشركة على عبادة الأوثان، أو القول بالثالوث، ونحو ذلك مما هو مخالف لصريح العقل، فهو من جنس ما يُعلم أنه من أثر التقليد والغلبة، فلا يكون دالًا على بداهة، ولا حجة على المخالف.
وأما القول في الخلاف أهو رافع للبداهة أم لا؟ فإن ذلك إنما يصح لو كانت أسباب الخلاف محصورة في عمل العقل السليم، وهو باطل؛ فإننا نعلم بالضرورة أن من الخلق من يختارون أعظم الأقوال سفسطة وظهورا في البطلان لأسباب لا يحصيها إلا الله، مرجعها إجمالا إلى النفس وهواها، كحب التميز والرياسة أو اتباع ما ألفوه من آبائهم ونحوه.
وقد يكون أصل الفساد من جهة النظر الكلي، ثم يُبنى عليه ما بعده، فيضل في الجزئيات تبعًا لذلك، وإن لم يكن له فيها هوى مخصوص، كما ترى من يسفسط في الأمور الظاهرة لكونه ألِف ضربًا من الجدل والمراء، ثم يطرد ذلك في مسائل لا موجب فيه لذلك لولا ما تقدمه؛ وهذا شأن عامة الفلاسفة.
ولهذا فحصول الخلاف في عصرنا حول قبح الشذوذ الجنسي -مثلا- لا يرفع حكم الفطرة بقبحه، لعلمنا بمداخل الهوى في قول المخالفين، وكون الحكم الأغلبي الذي يمتنع فيه التواطئ على خلافهم.
فإن أمكن – وهو عسير – أن تُعزل المؤثرات الخارجية، ويُتحقق تجرد العقل، وسلامة القصد، واستواء النظر بين المختلفين، ثم وُجد الخلاف في الحكم، دلّ ذلك على خفاء محل النزاع، وأنه ليس من الواضحات البدهيات.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
18.05.202523:30
18.05.202517:30
[هل يجوز استعمال قياسي الشمول والتمثيل في حق الباري؟]
.
نقول: جوَّزَ المتكلمون استعمال قياسِ الشمولِ في حق الباري سبحانه باتفاق، ومن جوّزَهُ ينبغي أن يجوِّزَ قياس التمثيل لما بيَّناه من جوازِ إرجاع أحدهما إلى الآخر، وكون الخلاف بينهما شكليًّا صوريًا لا حقيقيا، والأشعرية منهم اعتمدوا قياسَ التمثيل بالجوامع الأربعة -كما سيأتي- أما نحن فنقول:
لا يجوز استعمال هذين القياسين بإطلاق، وإنما على وجهٍ معين، إذ القياسان باعتبار قوة العلة المشتركة يستعملان على وجوه ثلاثة:
1 - القياس الأولوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، بأن تكون علة ثبوت الحكم في الفرع أشد وأقوى.
مثال: السبب المشترك في القياس (لله كمال وللمخلوق كمان، والله متصف باكمل الكمالات فالسبب فيه اقوى فان قيل المخلوق له حياة ونقيضها الموت نقص بالضرورة فاذا دل ان الله متصف بكمال الحياة من باب اولى لقوة سبب وصفنا به وهو كونه يستحق كل الكمالات بلا اي نقص
2 - القياس المساوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع مساويًا لثبوته في الأصل، للتساوي في علة ثبوت الحكم في الأصل والفرع.
وهذا لا يلزم منه الاشتراك كيفية كيفية الاتصاف فيقال كل موجود له حد وصفة ومكان وزمان يخصه
الله موجود = لن حد وصفة ومكان وزمان يخصه
3 - القياس الأدون: إن كان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل، لكون علة ثبوت الحكم في الأصل أشد منها في الفرع.
اذا كان المخلوق الناقص قد يتنزه غن البخل مع كون السبب الدافع للبخل فيه كبير وهو الافتقار والحاجة وقد علمنا ان الله غني عن كل شيء كان الزم لنا ان نصله بانن هو الكريم المتنزه عن البخل لان علة البخل فيه معدومة وهي العازة والحاجة فاذا سبب البخل فيه اقل بل هو معدوم بالكلية
ويسمى القياسان الأولان بـ "القياس في معنى الأصل" وبـ "القياس الجلي"، أما القياس الأولوي والمساوي فقطعيان، وأما القياس الأدون فظني.
ولا ينافي التفاوت في علة الحكم اشتراط وجود العلة بتمامها في الفرع ليثبت له حكم الأصل، إذ علة الحكم هنا هي القدر المشترك بين العلتين، الشديدة والضعيفة.
ويستعملان باعتبار الأصل المقيس عليه على وجهين، فإما أن يكون الأصل هو المخلوق وما ثبته له، أو يكون الأصل هو الخالق وما ثبت له:
1- فإن كان المخلوق هو الأصل في القياس؛ لم يجز في حق الله إلا القياس الأولوي، لأن الباري أولى بالحُكمِ الكمالي للوصف المشترك ممن هو دونه من المخلوقات في قياس التمثيل، وأولى بمحمولِ المقدمة الكبرى من غيره ممن يندرج في موضوعها، فيجوز في حقِّهِ قياسا التمثيل والشمول من هذا الوجه، ومن هذا الوجه فقط، ونمثِّلُ لذلك بالتالي:
الباري فاعلٌ مدركٌ سبحانه، وكلُّ فاعلٍ مُدرِكٍ حي، فالباري حيٌ من بابِ أولى.
وقد نعطي مثالًا ثانيًا فنقول:
الله عالمٌ بقبح بعض الأفعال ومستغنٍ عنها، وكلُّ عالمٍ بقبحِ فعلٍ ومستغنٍ عنه لا يفعله، فالله لا يفعل ما هو قبيح.
وكذلك قد نقول:
الله فَعَل أفعالاً متقنةً معقدةً مركبةً لتحقيق غاية، وكل من فعلَ فعلاً هذه صفته فهو عالمٌ حكيم، فالله عالمٌ حكيم.
2- وإن لم يكن الأصل هو المخلوق أو ما يقوم به، بل أفعال الخالق وصفاته سبحانه، جازَ حينئذٍ القياسان، المساوي والأولوي.
كقوله تعالى: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون} [الرُّوم: 19] حيث قاس إخراج الناس من قبورهم أحياءً بعد موتهم بإحياء الأرض بعد موتها، وكلاهما -الأصل والفرع- فعله سبحانه.
------------------------------
[خطأ مشتهر في نسبة منع القياسين لابن تيمية]
.
كثيرًا ما فُهِمَ أن ابن تيمية يمنع قياسي الشمول والتمثيل مطلقًا ويجيزُ قياس الأولى، والخلاف مع من يفهم مثل هذا لفظي، إذ يجعلون قياس الأولى قسيمًا لقياسي الشمول والتمثيل، لا وجهًا من أوجه استعمالهما، ويقصرون قياس الشمول على ما تستوي أفراده، فلا يطلقون «قياس الشمول» إلا على ما كان بهذه الصفة، ويقصرون قياس التمثيل على ما يستوي فيه الأصل والفرع.
وهذا وإن كانَ خلافًا لفظيًّا إلا أنه مخالف لاصطلاح أهل الفن، ونسبته لابن تيمية نسبةٌ غير دقيقة، إذ هو يقّيِدُ دائمًا قياسي الشمول والتمثيل الممنوعين، ولا يمنعهما بإطلاق، فيقول: «ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده... ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواءٌ كان تمثيلاً أو شمولاً».
فلا يهم عنده كون القياس تمثيلاً أو شمولاً، المهم أن يكون أولويًّا لا باستواءِ أصلٍ وفرعٍ أو استواءِ أفرادٍ في قضيةٍ كلية، ويقول: «واستعمال كلا القياسين في الأمور الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى»"
منقول بتصرف يسير
.
نقول: جوَّزَ المتكلمون استعمال قياسِ الشمولِ في حق الباري سبحانه باتفاق، ومن جوّزَهُ ينبغي أن يجوِّزَ قياس التمثيل لما بيَّناه من جوازِ إرجاع أحدهما إلى الآخر، وكون الخلاف بينهما شكليًّا صوريًا لا حقيقيا، والأشعرية منهم اعتمدوا قياسَ التمثيل بالجوامع الأربعة -كما سيأتي- أما نحن فنقول:
لا يجوز استعمال هذين القياسين بإطلاق، وإنما على وجهٍ معين، إذ القياسان باعتبار قوة العلة المشتركة يستعملان على وجوه ثلاثة:
1 - القياس الأولوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، بأن تكون علة ثبوت الحكم في الفرع أشد وأقوى.
مثال: السبب المشترك في القياس (لله كمال وللمخلوق كمان، والله متصف باكمل الكمالات فالسبب فيه اقوى فان قيل المخلوق له حياة ونقيضها الموت نقص بالضرورة فاذا دل ان الله متصف بكمال الحياة من باب اولى لقوة سبب وصفنا به وهو كونه يستحق كل الكمالات بلا اي نقص
2 - القياس المساوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع مساويًا لثبوته في الأصل، للتساوي في علة ثبوت الحكم في الأصل والفرع.
وهذا لا يلزم منه الاشتراك كيفية كيفية الاتصاف فيقال كل موجود له حد وصفة ومكان وزمان يخصه
الله موجود = لن حد وصفة ومكان وزمان يخصه
3 - القياس الأدون: إن كان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل، لكون علة ثبوت الحكم في الأصل أشد منها في الفرع.
اذا كان المخلوق الناقص قد يتنزه غن البخل مع كون السبب الدافع للبخل فيه كبير وهو الافتقار والحاجة وقد علمنا ان الله غني عن كل شيء كان الزم لنا ان نصله بانن هو الكريم المتنزه عن البخل لان علة البخل فيه معدومة وهي العازة والحاجة فاذا سبب البخل فيه اقل بل هو معدوم بالكلية
ويسمى القياسان الأولان بـ "القياس في معنى الأصل" وبـ "القياس الجلي"، أما القياس الأولوي والمساوي فقطعيان، وأما القياس الأدون فظني.
ولا ينافي التفاوت في علة الحكم اشتراط وجود العلة بتمامها في الفرع ليثبت له حكم الأصل، إذ علة الحكم هنا هي القدر المشترك بين العلتين، الشديدة والضعيفة.
ويستعملان باعتبار الأصل المقيس عليه على وجهين، فإما أن يكون الأصل هو المخلوق وما ثبته له، أو يكون الأصل هو الخالق وما ثبت له:
1- فإن كان المخلوق هو الأصل في القياس؛ لم يجز في حق الله إلا القياس الأولوي، لأن الباري أولى بالحُكمِ الكمالي للوصف المشترك ممن هو دونه من المخلوقات في قياس التمثيل، وأولى بمحمولِ المقدمة الكبرى من غيره ممن يندرج في موضوعها، فيجوز في حقِّهِ قياسا التمثيل والشمول من هذا الوجه، ومن هذا الوجه فقط، ونمثِّلُ لذلك بالتالي:
الباري فاعلٌ مدركٌ سبحانه، وكلُّ فاعلٍ مُدرِكٍ حي، فالباري حيٌ من بابِ أولى.
وقد نعطي مثالًا ثانيًا فنقول:
الله عالمٌ بقبح بعض الأفعال ومستغنٍ عنها، وكلُّ عالمٍ بقبحِ فعلٍ ومستغنٍ عنه لا يفعله، فالله لا يفعل ما هو قبيح.
وكذلك قد نقول:
الله فَعَل أفعالاً متقنةً معقدةً مركبةً لتحقيق غاية، وكل من فعلَ فعلاً هذه صفته فهو عالمٌ حكيم، فالله عالمٌ حكيم.
2- وإن لم يكن الأصل هو المخلوق أو ما يقوم به، بل أفعال الخالق وصفاته سبحانه، جازَ حينئذٍ القياسان، المساوي والأولوي.
كقوله تعالى: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون} [الرُّوم: 19] حيث قاس إخراج الناس من قبورهم أحياءً بعد موتهم بإحياء الأرض بعد موتها، وكلاهما -الأصل والفرع- فعله سبحانه.
------------------------------
[خطأ مشتهر في نسبة منع القياسين لابن تيمية]
.
كثيرًا ما فُهِمَ أن ابن تيمية يمنع قياسي الشمول والتمثيل مطلقًا ويجيزُ قياس الأولى، والخلاف مع من يفهم مثل هذا لفظي، إذ يجعلون قياس الأولى قسيمًا لقياسي الشمول والتمثيل، لا وجهًا من أوجه استعمالهما، ويقصرون قياس الشمول على ما تستوي أفراده، فلا يطلقون «قياس الشمول» إلا على ما كان بهذه الصفة، ويقصرون قياس التمثيل على ما يستوي فيه الأصل والفرع.
وهذا وإن كانَ خلافًا لفظيًّا إلا أنه مخالف لاصطلاح أهل الفن، ونسبته لابن تيمية نسبةٌ غير دقيقة، إذ هو يقّيِدُ دائمًا قياسي الشمول والتمثيل الممنوعين، ولا يمنعهما بإطلاق، فيقول: «ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده... ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواءٌ كان تمثيلاً أو شمولاً».
فلا يهم عنده كون القياس تمثيلاً أو شمولاً، المهم أن يكون أولويًّا لا باستواءِ أصلٍ وفرعٍ أو استواءِ أفرادٍ في قضيةٍ كلية، ويقول: «واستعمال كلا القياسين في الأمور الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى»"
منقول بتصرف يسير
18.05.202517:30
转发自:
قناة || م أ
17.05.202508:46
"بل هذا شأنُ كلِّ من نظر في الأمور التي فيها دقَّةٌ ولها نوعُ إحاطة، كما تجدُ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق، وأن أهلَه يتكلَّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد, فالمعاني فطريةٌ عقليةٌ لا تحتاجُ إلى وضعٍ خاص، بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ، فإنها تتنوَّع، فمتى تعلموا أكمل الصُّور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أكملَ وأنفعَ وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعةٍ اصطلاحيةٍ في أمورٍ فطريةٍ عقليةٍ لا يُحْتاجُ فيها إلى اصطلاحٍ خاص."
ابن تيمية
.
قلت: وذا ملمح ذكيٌ آخر في علقة القوالب بالمعاني وتفاضلها في قدح هذه المعاني مما يعلي شأن منطق العرب في لغتهم على منطق الأعاجم.
ابن تيمية
.
قلت: وذا ملمح ذكيٌ آخر في علقة القوالب بالمعاني وتفاضلها في قدح هذه المعاني مما يعلي شأن منطق العرب في لغتهم على منطق الأعاجم.
转发自:
قناة || م أ
17.05.202508:46
بح صوتي بهذه الفكرة، ولم أكن قرأتها لأحد إلا أن تكون بذرتها في مناظرة السيرافي ومتى بن يونس، ولذا كانت لغة المرء شطر عقله، ومنطق العرب في بلاغتهم نثرا وشعرا أعلى من قوالب فهم وضعت لأهل البلادة ثم تولدت منها تجريدات وتشقيقات واصطلاحات لا يحتاجها ذكي، فها هم عقلاء البشر -حتى الذين برزوا في حرفة المنطق- يُجرون في منطوقهم ومكتوبهم التعاريف والحجج، ويكشفون معاقد الخطأ، دون ليّ أشداقهم بشيء من تلك الرسوم. وها هم كبار المناطقة بين يديك، لم تُعصَم أهم أفكارهم التي يقطعون بها عند جمهور العقلاء. فدونك ابن سينا الذي نابذه جمهور المسلمين في مسائل كبار، ودونك الرازي الذي أجلَب على أصول مذهبه فأنكره رجال من الداخل دع الخارجين. وكأن الله قضى أن تخذل هذه الآلة كل من أخذها بقوة وصار فيها رأسا، إذ لا تجد قائمًا بها إلا وهو مغموط في جهة من جهات تفكيره، وقد تكون أعلى الجهات وأولاها بالحياطة من الخطأ كالعقيدة. ثم إني لا أحصي كم شابًا بليدًا لم يفده المنطق إلا أن زاد على بلادته عجمة تلك الرسوم، فألبساها ثوبي زورٍ بعدما كانت بلادةً جلية، وكم شابًا تزود من لغة العرب فلم يلبث قليلًا حتى كسته مهابة بيانهم وتضوعت منه حكمتهم.
ولا تهجم قبل أن تنتبه للفرق بين عدم الحاجة وعدم الفائدة، أو بين بحث الصورة الذي غلب الكلام عنه وبحث المادة المندرج بأخرة في نظرية المعرفة، أو بين الحاجة الصناعية الطارئة والحاجة الأصلية. ولا تهجم وأنت تحسب الكاتب لم يدرُس منه ويدرِّس ما هو منتهى طموحك إن بَلَغت.
ولا تهجم قبل أن تنتبه للفرق بين عدم الحاجة وعدم الفائدة، أو بين بحث الصورة الذي غلب الكلام عنه وبحث المادة المندرج بأخرة في نظرية المعرفة، أو بين الحاجة الصناعية الطارئة والحاجة الأصلية. ولا تهجم وأنت تحسب الكاتب لم يدرُس منه ويدرِّس ما هو منتهى طموحك إن بَلَغت.
17.05.202508:46
المنطق مودع في كلام العرب!
«وليكن في علمك أن علم العربية مع كونه بالذات لإصلاح اللسان، لم يخل من المعاني التي ترتاض بها الأذهان حتى تناول علم المنطق. فكان له فيه النصيب الوافر، يعرفه من له خبرة بالعلمين، وفطانة عند موقع النظرين.
فانظر مثلا في الاستعارة التصريحية كقولك: رأيت أسدًا يرمي، تجدها قياسًا من الشكل الأول، حذفت كبراه والنتيجة؛ لوضوحهما. وبيانه: أن المشبه المطوي كـ "زید" مثلًا هو المتحدث عنه بأنه أسد، وكل أسد شجاع، فـ "زيد شجاع" بهذا الدليل.
وبهذا تفهم قول البيانيين: إن المجاز أبلغ لأنه كدعوى الشيء ببينة؛ إشارة إلى ما ذكرنا.
وانظر أيضا إلى الكناية فإنها تنقسم عندهم:
• إلى ما يطلب بها المفرد وهذا من باب المعرفات لطلب التصور، فإذا قلت: رأيت حيا عريض الأظفار، مستوي القامة، فهو تصوير للإنسان بهذا الرسم. وهذا أحد قسمي المنطق.
• وإلى ما يطلب بها النسبة وهذا قياس كالأول، فإذا قلت: فلان كثير الرماد، فهو استدلال، أي وكل الكثير الرماد مضياف، وهذا واضح. ولهذا أيضا قالوا: الكناية أبلغ من التصريح.
فالمنطق مودع في كلام العرب، ولا يضر كون كثير منها خطابيات وإقناعيات؛ لأن المنطق صادق بالصناعات الخمس كلها كما مر التنبيه. ومن تتبع الاستدلالات الشعريات وجد أمرًا كثيرًا، فاعرف ذلك. وإنما ذلك لأن المنطق مركوز في الفطر، لا يختص به الحكماء وإن كانوا قد تنبهوا فيه لبعض ما لم يتنبه إليه غيرهم من الكيفيات والشرائط، صورة ومادة».
أبو علي اليوسي تـ1102هـ/1691م
@ https://t.me/IFALajmi/2921
«وليكن في علمك أن علم العربية مع كونه بالذات لإصلاح اللسان، لم يخل من المعاني التي ترتاض بها الأذهان حتى تناول علم المنطق. فكان له فيه النصيب الوافر، يعرفه من له خبرة بالعلمين، وفطانة عند موقع النظرين.
فانظر مثلا في الاستعارة التصريحية كقولك: رأيت أسدًا يرمي، تجدها قياسًا من الشكل الأول، حذفت كبراه والنتيجة؛ لوضوحهما. وبيانه: أن المشبه المطوي كـ "زید" مثلًا هو المتحدث عنه بأنه أسد، وكل أسد شجاع، فـ "زيد شجاع" بهذا الدليل.
وبهذا تفهم قول البيانيين: إن المجاز أبلغ لأنه كدعوى الشيء ببينة؛ إشارة إلى ما ذكرنا.
وانظر أيضا إلى الكناية فإنها تنقسم عندهم:
• إلى ما يطلب بها المفرد وهذا من باب المعرفات لطلب التصور، فإذا قلت: رأيت حيا عريض الأظفار، مستوي القامة، فهو تصوير للإنسان بهذا الرسم. وهذا أحد قسمي المنطق.
• وإلى ما يطلب بها النسبة وهذا قياس كالأول، فإذا قلت: فلان كثير الرماد، فهو استدلال، أي وكل الكثير الرماد مضياف، وهذا واضح. ولهذا أيضا قالوا: الكناية أبلغ من التصريح.
فالمنطق مودع في كلام العرب، ولا يضر كون كثير منها خطابيات وإقناعيات؛ لأن المنطق صادق بالصناعات الخمس كلها كما مر التنبيه. ومن تتبع الاستدلالات الشعريات وجد أمرًا كثيرًا، فاعرف ذلك. وإنما ذلك لأن المنطق مركوز في الفطر، لا يختص به الحكماء وإن كانوا قد تنبهوا فيه لبعض ما لم يتنبه إليه غيرهم من الكيفيات والشرائط، صورة ومادة».
أبو علي اليوسي تـ1102هـ/1691م
@ https://t.me/IFALajmi/2921
17.05.202508:46
17.05.202508:00
اترك الحصان الميت || آدم بن صقر الصقور
https://youtube.com/watch?v=kCZA6vSbnqo&si=mK2F2YVrsp7XEZwp
https://youtube.com/watch?v=kCZA6vSbnqo&si=mK2F2YVrsp7XEZwp
记录
20.05.202523:59
529订阅者22.04.202518:11
100引用指数18.05.202500:33
625每帖平均覆盖率16.05.202517:19
220广告帖子的平均覆盖率12.05.202523:59
6.25%ER17.05.202523:59
119.27%ERR登录以解锁更多功能。